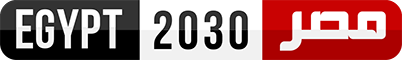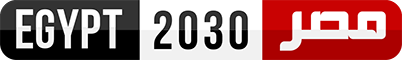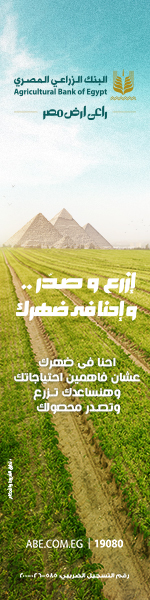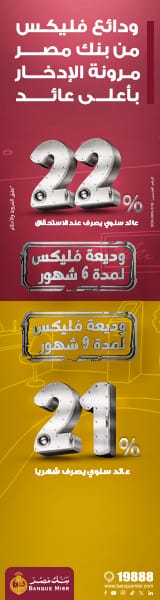مفتشة آثار تحكي لـ«مصر2030» تاريخ بداية الشمعدان في الفن الإسلامي


قالت مفتشة أول آثار، إن صناعة الشمعدان أو حامل الشموع تعكس جانبا مهما وتطور عمارة القصور قديما، بدءا من القرن السادس الهجري، مشيرة إلى أنه مع بناء القاعات الشاهقة والمتسعة لم تعد المسارج الصغيرة أو المصابيح الزجاجية المعلقة بالأسقف، وهي قادرة على توفير الإضاءة المناسبة لأجواء البلاط.
وأضافت مجدي، في تصريحات لـ «مصر2030»، أن قديما ظهرت الحاجة إلى استخدام الشموع الضخمة المعروفة (المواكبية)، وهي تلك القطع الضخمة من الشمع التي كانت تحمل في الليل لإضاءة مواكب الحكام، ولكن مع توفير مكان ثابت للشمعدان قريب من أولي الأمر، سرعان ما أصبح الشمعدان علامة على المكانة الاجتماعية الرفيعة لكل من يشتريه.
وتابعت: عرفت الشماعد المصنوعة غالباً من المعادن طريقها إلى أرجاء العالم الإسلامي كافة، من خراسان شرقاً إلى مصر والشام غرباً، قائلة إنه أثناء فترة دولة السلاجقة على أراض الدولة العباسية في آسيا، اتيح انتشاراً للشماعد البرونزية والنحاسية.
وأكملت أنه خلال غزوات المغول في منتصف القرن السابع الهجري علي أرجاء آسيا التي انتهت بإسقاط دولة الخلافة العباسية والاستيلاء على بغداد في عام 656 هـ «1258 م»، فقد أدت هجمات المغول المدمرة إلى هجرة صناع المعادن من العراق وشرقي الأناضول إلى مصر والشام بحثاً عن ملاذ آمن وطلباً للرزق في دولة كانت آنذاك، أصبحت المتحكم الرئيسي في الطريق البحري للتجارة العالمية بين الشرق والغرب.
وأوضحت أن القرن الثامن الهجري يعد العصر الذهبي للشماعد المعدنية، فنجدها في العراق وخراسان والأناضول، وإيران، وبلاد الشام، ومصر، ولدينا من العراق في تلك الفترة التي كانت السيطرة فيها لملوك المغول، شمعدان من النحاس الأصفر وهو مشكل بأسلوب الطرق.
وقالت إن هناك شماعد تاريخية من العصر المملوكي لأنها تحمل أسماء أمراء أو سلاطين أو زوجات لبعض السلاطين، وقد تطورت بعد ذلك أشكال الشماعد بصورة كبيرة في القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة، لتسمح بحمل أكثر من شمعة واحدة لتعزيز إضاءة الشموع.
وتابعت أنه من الطريف أن صناع الزجاج في بلاد الشام، أقدموا على محاكاة أشكال الشمعدان المخروطي، ولدينا من هذا النوع شمعدان يعود لحوالي عام 683 أو 684 هـ، أي من فترة الحكم الأيوبي، ورغم أنه أقل ثمنا من نظيره المعدني، إلا أنه لا يقل عنه جمالاً وتأنقاً بزخارفه الهندسية النجمية وكتاباته النسخية.