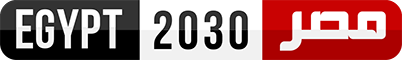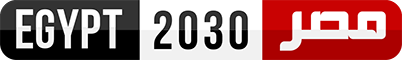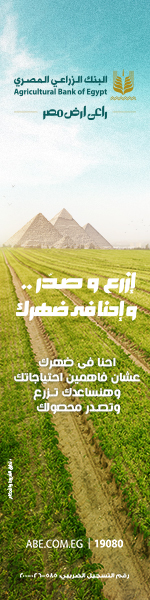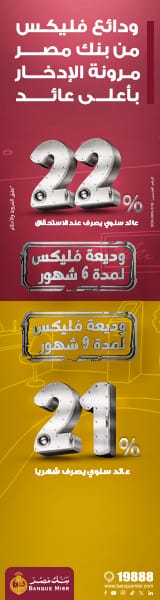تعرف على سر تحنيط المصري القديم للحيوانات (صور)


لقد برع المصرى القديم فى كل ما يتعلق بالطقوس اللازمة للحياة الأبدية التي تعقب الموت، فعقب ظهور الإلهة أوزوريس أصبح الاستعداد للموت مفهومًا راسخًا في العقل الجمعي للمجتمع المصري القديم، ما دفعه للجوء لفكرة التحنيط، والتي لا يعلم أحد سرها حتى الآن، ولكن نظراً لأهمية هذا العلم فقد وصلنا لمرحلة إنشاء متحف متخصص فقط في التحنيط، وهو "متحف التحنيط بالأقصر"، والذي يبرز تقنيات فن التحنيط الفرعوني القديم التي طبقها المصريين القدماء على العديد من المخلوقات وليس على البشر فقط، حيث يعرض في هذا المتحف الفريد مومياوات لقطط وأسماك وتماسيح، وخلال السطور القادمة سوف نستعرض السبب وراء اهتمام القدماء بفكرة التحنيط عموماً، وتحنيط الحيوانات بشكل خاص.
-الجانب الأثري وأهمية الحيوانات عند المصري القديم
قال الدكتور الحسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن روح التدين قد غلبت على المصري القديم منذ بدايات وجود الإنسان المصري على أرض مصر الطيبة، وكانت الحيوانات بأنواعها المختلفة تشاركه بيئته الفسيحة المليئة بكل الكائنات، ولم تكن لديه القدرة للسيطرة عليها، فأدرك مع الوقت أن لهذه الحيوانات قدرة عظيمة أكبر من قدرته هو ذاته، ومن هنا امتد التقديس والحب والتبجيل لهذه الحيوانات خوفا منها، ونظرا لما لها من قدرة وقوة أكبر من قدرته وقوته، فمال إلى تقديسها إتقاءً لبطشها وتهدئة لها ودرءًا لشرها، بالإضافة إلى رغبته في الإحتماء بها وبقوتها من الكائنات والظواهر الأخرى المحيطة به والتي تفوق قدرته المحدودة.
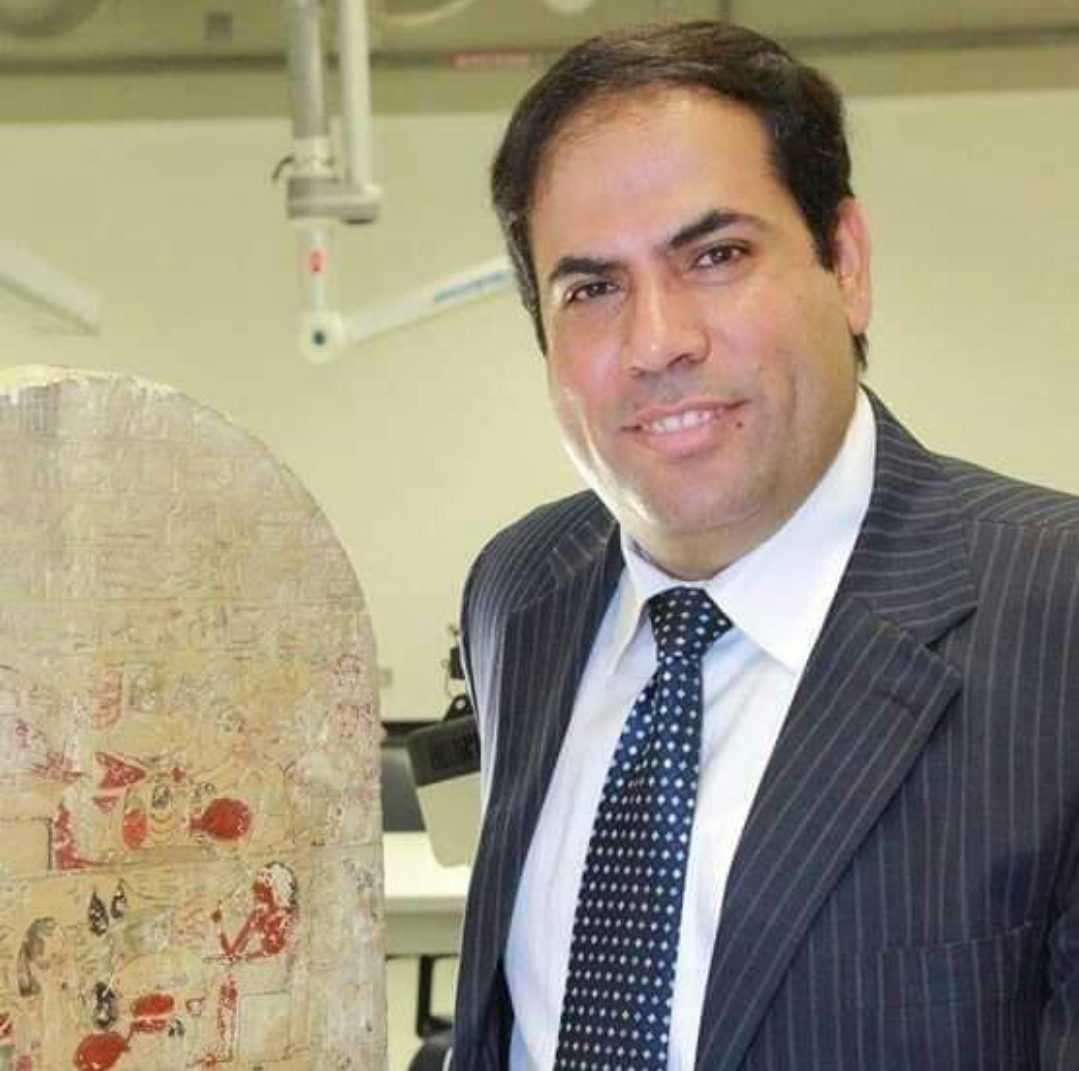
الدكتور الحسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية
وتابع "لا يمكننا أن ننسى إعجاب الإنسان المصري بقوة الحيوانات الخارقة التي كان يفتقر إليها، والتي امتازت بقدرتها على إمداده بقدر كبير من الخيرات التي كانت تجلبها له مثل الألبان واللحوم التي كان يقتات عليها، بجانب الجلود التي كانت تقيه من قسوة البرد في الشتاء، فنشأ بينه وبين تلك الحيوانات نوع غير محدود من الألفة غير المعلنة، فأسبغ عليها بالغ القداسة والاهتمام والتبجيل.
وأوضح "تقديس الحيوان كان معروفًا في مصر منذ أقدم العصور، واختفى مع الوقت لكن صار التقديس نوعًا من الاحترام وتقليد متوارث منذ القدم إلى العصور التاريخية، غير أن السبب الأهم في احترام وتقديس الحيوان في مصر القديمة والدافع من وراء عبادته يرجع أغلب الظن إلى أن المصري القديم قدس الروح السامية الكامنة في الحيوان، وليس الحيوان ذاته، وهذا لم يكن مع كل أنواع الحيوانات، كما يحدث الآن في الهند من تقديس لجميع أنواع الأبقار، وإنما كان الاختيار يقع على نوع محدد من الحيوان.
وأشار " إن اختيار الحيوان المحدد تقديسه كان يتم عن طريق مجموعة من العلماء في "برعنخ" أو "بيت الحياة"، مكان العلم والعلماء الموجود في المعابد بمصر القديمة، ومتى تم توافر الشروط المطلوبة بدقة في ذلك الحيوان، يتم الإعلان عن اختيار ذلك الحيوان المقدس، وتُقام الاحتفالات العظيمة في المعبد الخاص بالإله، وعند وفاة هذا الحيوان، يتم تحنيطه ودفنه في موكب عظيم.

ولفت "عبدالبصير" إن الحيوان كان وسيطاً بين الإنسان المصري القديم وبين الإله الذي كان يرمز إليه ذلك النوع من الحيوانات، لاسيما أن قدرة المعبود كانت تتجلى في هذا الرمز الحيواني، وتحول الأمر إلى نوع من القداسة التي وقرت روح الحيوان، لا الحيوان ذاته، وهذا توضيح عن ترفع الإله وتجرده عن الحالة المادية واختفاءه عن الأنظار، وتنزه الإله وارتفاعه إلى مرتبة عليا من السمو والتنزه عن الماديات الملموسة إلى العالم السماوي اللامادي حيث السمو بالذات إلى ملكوت التجرد عن كل الصفات الأرضية، وجاء هذا الاحترام من تقديس روح الإله الموجود في الحيوان، وليس في روح الحيوان، لذا فقد كانت الحيوانات المنزلية تنال قدراً كبيراً من عطف ورعاية المصري القديم في محيط الأسرة المصرية باعتبارها تمثل أرواحا طيبة في محيط بيت الأسرة.

وعن سبب اختيار المصري القديم لبعض هذه الحيوانات لتقديسها ومن ثم تحنيطها، قال عبدالبصير"لقد أخذ المصري القديم من البقرة قدرتها على الحنو على وليدها، ومن الكبش قدرته على الخصوبة والإنجاب، ومن الصقر بعده وارتفاعه في السماء، مما جعل من هذه الحيوانات أرواحا إلهية تكمن داخل معبوداتها، لذا فقد قام المصري القديم بتصوير الحيوانات المقدسة في هيئات مزجت مزجًا بارعًا بين الحيوان والإنسان، فنراها تظهر في هيئات نصف آدمية بجسد إنسان ورأس حيوان، وكان في هذا محاولة منهم لتقريب الصورة إلى الأذهان، وتم إطلاق اسم "أرواح المعبودات" على هذه المعبودات المقدسة، كما أنه تم إطلاق أسماء إلهية جديدة على الحيوانات المختارة بعناية فائقة لتمثل المعبود، فنرى الصقر يُطلق عليه اسم "حورس" وليس "بيك" بمعنى "الصقر" اسمه في اللغة المصرية القديمة، وأُطلق على البقرة "حتحور"، وليس "إيحت"، وأطلق على التمساح لقب الرب "سوبك"، وليس "مِسح"، معناه في مصر القديمة، وأصبح الكبش يأخذ اسم "آمون" أو "خُنوم"، وليس "با"، وتم تصوير العجل "أبيس"، روح المعبود بتاح، فى شكل حيواني خالص".
-الجانب "البيو آركيولوجي" وعلم التحنيط لدى المصريين القدماء
قالت الدكتورة زينب حشيش، مدير إدارة دراسة البقايا العظمية بالمخازن المتحفية بوزارة السياحة والآثار سابقاً، إن التحنيط يعد أحد أعظم العلوم التي توصل إليها المصري القديم، وقد ساعده في ذلك مناخ مصر الجاف الذي حافظ على الأجساد دون تحلل، فكانت للرمال الماصة للسوائل بالجسم دور السحر في بقاء الجسد جاف بالإضافة إلى الاختيار الجيد لمواقع الجبانات في أماكن مرتفعة".

الدكتورة زينب حشيش مدير إدارة دراسة البقايا العظمية بالمخازن المتحفية بوزارة السياحة والآثار سابقاً
وتابعت حشيش" إن كلمة حُنط الميت تعني علاج جسده بالمواد والعقاقير وحشو الجسد بالحنوط کي لا يفسد، والحنوط هي كل طيب يمنع الفساد"، مشيرة إلى أن هناك أكثر من لفظ يستخدم للتعبير عن التحنيط ومنهم (Embalm) وتعني (حنط) وهي من أصل لاتیني اسمه (balasmum) ، أي الحفظ في البلسم، أيضاً هناك لفظ (مومياء)، وقد يكون فارسياً بمعنى القار، حيث أنه أطلق في العصور المتأخرة على الجثث المصرية المحنطة، وذلك لقرب لونها من القار وهى تسميه غير دقيقة حيث أن القار لم يكن شائع الاستخدام في مصر، ولوحظ استخدامه أحيانا خلال العصر الفارسي".
وأوضحت حشيش " أن المصريين القدماء قد اتجهوا لعلم التحنيط رغبة في البقاء والحياة الأبدية في العالم الآخر، وكان المحرك الرئيسى للمصريين القدماء ليجنبوا أجساد موتاهم من الفساد هو الاستعانة بالجراحة والمواد الطبيعية والتي استخدموها كعقاقير، بجانب الرقى والتعاويذ واستخدام البخور لاستعادة الدفء للجسد ، وسكب السوائل المقدسة لاستعادة رطوبة الجسد".
وحول تحنيط المصريين القدماء للحيوانات قالت حشيش "إن الحيوانات المقدسة ظهرت منذ عصر مبكر جداً، حينما كان المرء يتخذ من المخلوقات ذاتها آلهة يتوجه إليها بالعبادة، أو ربما كانت الحيوانات المختلفة رموزاً مقدسة لأقاليم بذاتها، ثم باتت رموزاً لآلهة بعينها، ولم يعد لها من القداسة إلا صلتها بما تمثله من معبودات ولا تعبد لذاتها، وقد اعتاد المصري أن يتخذ بعض الحيوانات كرموز للآلهة فعلى سبيل المثال يظهر الإله (بتاح) في صورة عجل، والإله (آمون) في هيئة كبش أو أوزة، والآلهة (حتحور) في هيئة بقرة، والآلهة (باستت) في هيئة قطة".

وتابعت "في البداية قام المصريين القدماء بتحنيط الحيوانات المقدسة التي اختاروها لأسباب معينة لتعيش داخل المعبد وعند موتها تنتقل هذه الحيوانات إلى المحنطين لتتم العناية بها كما هو الحال بالنسبة للبشر، وبعد ذلك كانت تدفن مثل الحيوانات في مقابر جماعية، وكان لكل من هذه الحيوانات جبانة مخصصه لها مثل (السرابيوم) الذي كان مخصصا لدفن العجل المقدس بتاح، كذلك عٌثر بسقارة على العديد من الجبانات المخصصة لـ (قرود –جعارين –ثعابين كلاب- أيبس –فيران –ثور –أسد)، وفي أبيدوس عثر على جبانات (كلب –قطة- أبو منجل –سحلية –فيران –أسد)، وفي كفر حسن داود جبانات (بقر وغزال)، أما الأقصر فعٌثر فيها على جبانات (حصان – سحالي –قطط –فيران –أسد – أبو منجل – جعران – ثعبان)، وفي كوم إمبو عٌثر على جبانة (تمساح)".

وأضافت حشيش "أن مواد التحنيط المستخدمة مع البشر لم تكن مختلفة عن مواد التحنيط المستخدمة مع الحيوانات، مشيرة إلى أن المصري القديم قد استخدم العديد من مواد التحنيط مثل (ملح النطرون) والراتنجات المختلفة مثل (العرعر واللبان والمستكة والصمغ العربى وزيت الخروع وزيت الكندر وغيرها من المواد والزيوت المختلفة)".