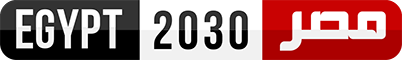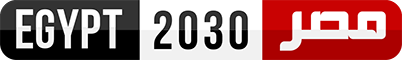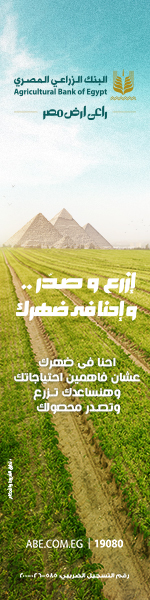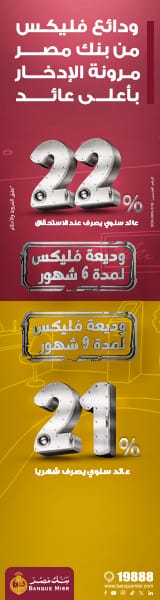خبير أثري : قدماء المصريين أول من اخترع أقدم تقويم فلكي


عندما نتحدث عن الحضارة المصرية القديمة " الفرعونية"، لابد أن يأتي في أذهاننا الإبداع الذي اشتهر به أصحاب تلك الحضارة ، التي ما زلنا ننبهر بها حتى وقتنا هذا، فعلى الرغم من التطور التكنولوجي الذي نعايشه في هذا العصر، إلا أننا ما زلنا نكتشف خبايا ومعلومات جديدة عن العلم الذي توصل إليه المصريون القدماء، الذين تركوا لنا إرثاً كبيراً سواء في حياتهم أو بعد مماتهم، لاسيما أنهم أبدعوا في جميع العلوم الحياتية والكيميائية والفلكية.
وعندما نتحدث عن الحياة الفلكية نجد أن قدماء المصريين هم أول من اخترع أقدم تقويم فلكي دقيق على وجه الأرض، وهذا ما أكده الباحث "أحمد عامر" الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات.
قال "عامر" إن المصريين القدماء دائما ما كانوا يبدعون في حياتهم، فقد برعوا في علم الفلك، بل وتفوقوا فيه، حيث نجدهم قد اخترعوا أقدم تقويم فلكي دقيق على وجه الأرض، و كان ذلك عام 4236 ق.م، ف قسموا السنة الى ثلاثة فصول هي: فصل الفيضان والذي يُعرف بإسم “آخت”، وفصل التحاريق والذي يُعرف باسم “بريت” ، وفصل الحصاد والذي يُعرف باسم “شمو”، ونجحوا في تقسيم السنة إلي 360 يوما، ووزعوها على 12 شهرا كل شهر 30 يوماً يُضاف إليها خمسة أيام في آخر العام عُرفت بأيام “النسيء” لاستكمال عدد أيام السنة وهي 365 يوماً، وكان كل فصل من فصول السنة يتكون من أربعة شهور، و كل شهر من ثلاثة أسابيع و كل أسبوع عشرة أيام، أما عن الأيام الخمسة التى تختم بها السنة فكانت أيام أعياد، ويقال إنها الأيام التى ولد فيها كل من “إيزيس”، و” أوزوريس”، و”ست”، و”نفتيس”، و”حورس”.
وأشار إلى أننا نجد التقويم المصرى “القبطى” هو تقويم شمسى يعتمد على دورة الشمس وهو من أوائل التقاويم التى عرفتها البشرية، كما أنه الأكثر دقة حتى الآن من حيث ظروف المناخ والزراعة خلال العام، ويعتمد عليه المزارع المصرى فى مواسم الزراعة والمحاصيل التى يقوم بزراعتها خلال العام منذ آلاف السنين و حتى وقتنا هذا، حيث إن السنة كانت تبدأ بثلاثة فصول هي كالتالي " فصل الفيضان والذي يبدأ من شهر يوليو حتى شهر أكتوبر، وثانيها فصل بذر البذور والذى يبدأ من نوفمبر حتي شهر مارس، وثالثها فصل الحصاد ويبدأ من شهر مارس حتي شهر يوليو، وهكذا تكونت السنة من اثني عشر شهراً، وكانت بداية العمل بهذا التقويم فى العام الأول من حكم الملك “حور_عا” ابن وخليفة الملك “مينا” عام 557 ق م طبقا لما أرخ له المؤرخ المصرى “مانيتون”، وقد اتخذ الاحتفال برأس السنة مظهراً دينياً يبدأ بنحر الذبائح كقرابين للإلهة، وتوزع لحومها على الفقراء، وكان جزء منها يوهب للمعابد يوزع بمعرفة الكهنة.
وتابع “عامر” أن سعف النخيل الأخضر الذى يرمز لبداية العام ويعبر عن الحياة المتجددة فى خروجه من قلب الشجرة يتبركون به ويصنعون منه ضفائر للزينة يعلقونها على الأبواب ويحملون باقات السعف لتوضع على المقابر فى عيد رأس السنة، بالإضافة إلي أنهم كانوا يوزعون ثمار النخيل الجافة “البلح” صدقة على أرواح موتاهم، بل وكانوا يصنعون من سعف النخيل أنواعاً مختلفة من التمائم والمعلقات التى يضعها الناس على صدورهم وحول أعناقهم رمزاً لتجدد الحياة فى العام الجديد، والحفظ من الأرواح الشريرة، وكان من تقاليد الاحتفال برأس السنة صناعة الكعك والفطائر، وانتقل التقليد ليلازم كل احتفالات الأعياد المسيحية والإسلامية، كما كان الأوز والبط من أكلاتهم المفضلة فى رأس السنة، كما كانوا يشربون عصير العنب أو النبيذ الطازج، بل كانوا ينتهزون فرصة عيد الميلاد لعقد زيجاتهم والتصالح بين الخصوم.
وأضاف أن استعراضات ومواكب الزهور ترجع إلى الملكة كليوباترا التي ابتدعتها، وذلك عندما توافق عيد جلوسها مع عيد الميلاد.